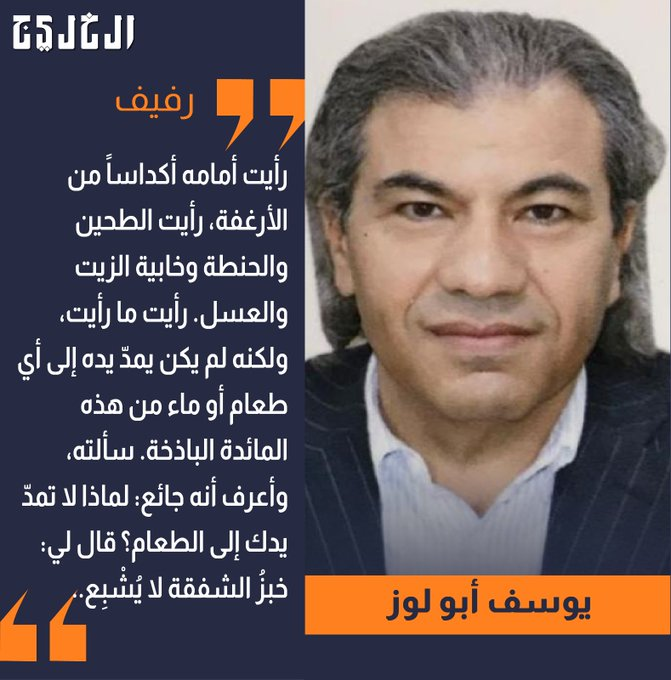سعيد العفاسي| من عمق الفكر إلى سؤال النهضة المؤجلة: عبد الرحمن بن خلدون بين التهميش العربي والاستثمار الغربي

في تاريخ الفكر العربي الإسلامي يقف عبد الرحمن بن خلدون بوصفه مفكّرًا إشكاليًا، لأنه تجاوز الأطر المألوفة للمعرفة، فأسّس علمًا جديدًا في فهم العمران البشري، وقارب التاريخ والاجتماع والسياسة والاقتصاد بمنهج نقدي صارم، يقوم على التعليل، والملاحظة، وربط الظواهر بسياقاتها، ورغم هذه المكانة الفريدة، ظلّ الفكر الخلدوني حاضرًا حضورًا منقوصًا في الوعي العربي، يُستدعى في المناسبات الخطابية، وفي المباحث الجامعية، ويُختزل في شعارات حول العصبية والدولة، دون الانخراط الحقيقي في عمقه النظري أو إمكاناته التطبيقية، هذا التأخر في الانفتاح على فكر ابن خلدون يثير أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة الثقافة العربية، وبعلاقتها بالسلطة، وبمنهجها في قراءة التراث، أول ما يلفت الانتباه في هذا السياق هو طبيعة الصدمة التي أحدثها ابن خلدون في بنية التفكير السائد في عصره، فقد خرج عن منطق السرد التاريخي القائم على النقل والتقديس، واقترح منهجًا يقوم على الشك المنهجي، والتحقق من الأخبار، وربط الوقائع بقوانين الاجتماع البشري، هذا التحول كان انقلابًا إبستمولوجيًا مسّ جوهر العلاقة بين المعرفة والسلطة، فالتاريخ عنده أصبح مجالًا لتحليل آليات نشوء الدول وانهيارها، ودراسة دور العصبية، والاقتصاد، والعمران، في صناعة السلطة، مثل هذا المنظور كان كفيلًا بإزعاج البنى السياسية التقليدية، لأنه يعرّي منطق الحكم، ويكشف طبيعته الدورية، ويضعه تحت مجهر التحليل.
من هنا يمكن فهم التوجّس العربي من الفكر الخلدوني بوصفه عرضًا بنيويًا لعلاقة مضطربة بين المعرفة والسلطة في التاريخ العربي-الإسلامي، فطوال قرون، تشكّلت الثقافة السياسية على قاعدة الحفاظ على الاستقرار السلطوي أكثر من انشغالها بإنتاج وعي نقدي قادر على مساءلة شروط الحكم وأسباب نشوئه وتحولاته، في مثل هذا السياق، لم تكن المعرفة أفقًا للتحرر أو أداة للفهم العميق، وإنما غدت في أغلب الأحوال جهازًا تبريريًا، يُستدعى لتثبيت القائم وإضفاء المشروعية عليه. من هنا، يظهر فكر عبد الرحمن بن خلدون كجسم غريب داخل هذا النسق، لأنه يقترح منذ القرن الرابع عشر تصورًا مغايرًا للدولة والسلطة والتاريخ، تصورًا يقوم على الفهم التحليلي لا على التسليم، وعلى الكشف لا على التقديس. ابن خلدون يزعزع، في عمق مشروعه، فكرة الدولة بوصفها قدرًا ثابتًا أو كيانًا متعاليًا عن التاريخ. الدولة عنده كائن اجتماعي-تاريخي، يولد وينمو ويشيخ ويفنى وفق قوانين يمكن رصدها وفهمها، هذا التصور ينزع عن السلطة هالتها الميتافيزيقية، ويعيدها إلى مجال الاجتماع البشري، حيث تخضع للتفاعل بين الاقتصاد، والعصبية، والعمران، والثقافة، ونمط العيش، وهنا يكمن الخطر الكامن في الفكر الخلدوني بالنسبة لثقافة سياسية تخشى الوعي التاريخي، لأن من يتعلم رؤية الدولة كظاهرة تاريخية يصبح قادرًا على التفكير في نهايتها، وفي شروط تجاوزها، وفي إمكان قيام بدائل لها. الوعي بهذه الدينامية يفتح الباب أمام مساءلة الشرعية، وهو باب ظل مغلقًا في أغلب التجارب العربية الحديثة والمعاصرة، غير أن العامل السياسي وحده لا يكفي لتفسير محدودية التفاعل العربي العميق مع ابن خلدون، ثمة عامل معرفي لا يقل أهمية، يتمثل في طبيعة التعليم العربي وطريقة تعامله مع التراث، فقد اعتاد هذا التعليم أن يتعامل مع الأعلام بوصفهم رموزًا مكتملة، لا بوصفهم مشاريع فكرية مفتوحة على التأويل والنقد. ابن خلدون يُقدَّم غالبًا باعتباره عبقريًا فذًا سبق عصره، ويُحتفى بـ”المقدمة” باعتبارها نصًا استثنائيًا، غير أن هذا الاحتفاء يبقى احتفاءً شكليًا، يكتفي بالترديد ولا ينفذ إلى البنية العميقة للفكر. تُستخرج مفاهيم مثل العصبية والدولة والعمران، وتُحوَّل إلى مصطلحات جاهزة، تُدرّس بمعزل عن النسق النظري الذي يمنحها معناها وقوتها التفسيرية، هذا التفكيك السطحي للفكر الخلدوني يؤدي إلى إفراغه من طاقته النقدية. فالعصبية، في تصور ابن خلدون، ليست مجرد رابطة قبلية أو انتماء دموي، هي مفهوم مركزي يعبّر عن طاقة التضامن الاجتماعي التي تتشكل في سياقات اقتصادية وبيئية محددة، وتتبدل بتبدل أنماط العيش والعمران. هي مرتبطة بالبداوة والحضر، بالخشونة والترف، بالعمل والإنتاج، وبالتحولات الثقافية التي ترافق انتقال الجماعات من نمط إلى آخر. فصل العصبية عن هذه الشبكة المفهومية الواسعة يحولها إلى شعار فارغ، ويجعل قراءتها أقرب إلى الوعظ أو التبسيط، وهو الأسلوب نفسه الذي وجّه إليه ابن خلدون نقدًا لاذعًا حين تحدث عن المؤرخين الذين يكتفون بسرد الأخبار دون تمحيص أو تعليل.
إلى جانب ذلك، يشكل الأسلوب اللغوي والمنهجي لابن خلدون عائقًا إضافيًا أمام التلقي المعاصر. لغته كثيفة، ومشحونة بالمفاهيم، ومبنية على تركيب منطقي دقيق يفترض قارئًا متمرّسًا في الفلسفة والتاريخ والفقه وعلم الكلام. القارئ الذي يفتقر إلى هذا التمرس يجد نفسه أمام نص عصيّ على الفهم السريع، فيميل إلى الاختزال، أو يكتفي بقراءة “المقدمة” وحدها، متجاهلًا المشروع الموسوعي المتكامل الذي يتمثل في “كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”، هذا الاختزال رسّخ صورة ابن خلدون كمفكر معقد يُستحسن الإعجاب به من بعيد، دون محاولة استخدام أدواته في تحليل الواقع المعاصر، والحال أن هذا التعقيد ليس عيبًا في الفكر الخلدوني، ولكنه هو مصدر قوته. ابن خلدون لم يسعَ إلى تبسيط الواقع على حساب دقته، وإنما حاول الإمساك بتشابكه وتعقيده. مشروعه يقوم على الربط بين المستويات المختلفة للظاهرة الاجتماعية، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن الثقافة إلى الجغرافيا. هذا الربط هو ما يجعل فكره صالحًا للتوظيف التحليلي، شريطة التعامل معه بوصفه منهجًا لا مجرد تراث. على النقيض من هذا الاستقبال العربي المتحفظ، وجد الفكر الخلدوني في أوروبا الحديثة سياقًا معرفيًا أكثر استعدادًا لتلقيه. أوروبا، الخارجة تدريجيًا من هيمنة التفسير اللاهوتي للتاريخ، كانت تبحث عن أدوات جديدة لفهم المجتمع بوصفه نسقًا تحكمه قوانين داخلية. عبر الترجمات والدراسات الاستشراقية، تم التعرف إلى ابن خلدون باعتباره نموذجًا مبكرًا للعقل التاريخي النقدي. لم يكن تأثيره جماهيريًا، ولم يتحول إلى مرجع شعبي، غير أن حضوره كان لافتًا داخل الدوائر الفكرية التي أسست لاحقًا لعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ. مفكرون مثل فيكو ومونتسكيو وجدوا في المنهج الخلدوني ما ينسجم مع محاولاتهم لفهم القوانين التي تحكم تطور المجتمعات، من حيث علاقتها بالبيئة والعادات ونظم الحكم. وفي مراحل لاحقة، بدا التقاطع أوضح مع تصورات دوركهايم حول الوقائع الاجتماعية بوصفها ظواهر لها وجود مستقل عن الأفراد، ويمكن دراستها علميًا. هذا الاستقبال الأوروبي لم يكن نتيجة تفوق ثقافي بقدر ما كان تعبيرًا عن اختلاف في الشروط المعرفية والسياسية التي تسمح للفكر النقدي بأن يجد موطئ قدم. في ضوء ذلك، يمكن القول إن إعادة اكتشاف ابن خلدون عربيًا تقتضي أكثر من الاحتفاء باسمه أو ترديد مقولاته الشهيرة. هي تتطلب مراجعة جذرية لعلاقتنا بالتراث، وبالمعرفة، وبالسلطة. تتطلب تعليمًا يُدرّب على القراءة النسقية، وعلى الربط بين المفاهيم، وعلى استخدام الفكر أداة للفهم لا زينة ثقافية. عندها فقط يمكن للفكر الخلدوني أن يستعيد دوره الحقيقي، على اعتباره مشروعًا نقديًا حيًا، قادرًا على إضاءة الحاضر وكشف آلياته العميقة.
الفرق الجوهري بين استقبال أوروبا للفكر الخلدوني واستقباله في السياق العربي يكمن في طبيعة هذا الاستقبال ووظيفته المعرفية، ففي أوروبا، جرى التعامل مع ابن خلدون بوصفه مفكرًا قبل أن يكون رمزًا حضاريًا، وبوصفه صاحب مشروع معرفي قابل للفهم والتفكيك وإعادة التوظيف. لم تُختزل علاقته به في “المقدمة” وحدها، غير أنه كتابه الموسوعي الكبير، “كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر” خضع لقراءات دقيقة حاولت استيعاب بنيته الداخلية ومنطقه التفسيري وأدواته التحليلية. هذا التفكيك كان وسيلة لفهم أنماط التفكير في المجتمعات العربية والإسلامية، وكيفية تشكّل السلطة والعمران والتاريخ داخلها. انطلقت هذه القراءة الأوروبية من دافع معرفي مزدوج: أولهما رغبة في فهم “الآخر” العربي فهمًا عميقًا، ليس عبر الصور النمطية أو الأحكام المسبقة، وإنما من خلال عقلٍ أنتج تفسيرًا ذاتيًا لتاريخه ومجتمعه. وثانيهما السعي إلى تجاوز هذا الفكر ذاته عبر تطويره والبناء عليه. فابن خلدون لم يُقرأ هناك بوصفه نهاية لمسار فكري، ولكن باعتباره نقطة انطلاق، أو حلقة تأسيسية في تاريخ التفكير في الاجتماع والتاريخ. لذلك، جرى التعامل مع مفاهيمه، مثل العصبية والعمران والدولة والدورة التاريخية، باعتبارها أدوات تحليلية مفتوحة، قابلة للتعديل والنقد والتجاوز، لا باعتبارها مسلّمات نهائية أو نصوصًا مغلقة. هذا التعامل الأداتي والنقدي مع الفكر الخلدوني أتاح إدماجه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تشكّل علوم جديدة، مثل علم الاجتماع وفلسفة التاريخ والأنثروبولوجيا السياسية. ولم يكن من الضروري، في كثير من الأحيان، الإحالة الصريحة إلى اسم ابن خلدون، لأن أفكاره كانت قد تحوّلت إلى جزء من البنية العميقة للتفكير الأوروبي الحديث. لقد تم استيعابه في المنهج، لا في الشعارات، وفي الآليات التحليلية، لا في الاحتفاء الخطابي.
في المقابل، ظل ابن خلدون في السياق العربي محاطًا بهالة تقديسية عطّلت إمكان القراءة النقدية الخلّاقة، وأُدرج اسمه ضمن قائمة “العباقرة” الذين يُستشهد بهم للفخر بالماضي، أو يستعمل لإنجاز بحوث جامعية تبقى حبيسة الرفوف، وتقام الندوات لتدارس فكر ابن خلدون دون تطبيقه على أرض الواقع، أكثر مما يُستدعى مشروعه بوصفه أداة لفهم الحاضر. هذا التقديس جعل الاقتراب التحليلي من فكره يبدو وكأنه مساس بمكانته، مع أن جوهر مشروعه قائم أصلًا على الشك في الروايات السائدة، ونقد المسلّمات، وتفكيك آليات التفكير التاريخي التقليدي. المفارقة أن ابن خلدون، الذي ثار على النقل غير الممحّص وعلى السرد التمجيدي للتاريخ، تحوّل في الوعي العربي إلى موضوع لنوع جديد من النقل غير النقدي. من هنا، لا يكمن التحدي في إعادة الاعتبار لابن خلدون بوصفه مفكرًا عظيمًا، فذلك أمر محسوم، وإنما في تحرير فكره من التقديس الذي يجمّده، وإعادته إلى مجاله الطبيعي، مجال السؤال والتحليل والنقد، حينها فقط يمكن للفكر الخلدوني أن يستعيد فاعليته، كمنهج يُستخدم ويُختبر ويُطوَّر في مواجهة أسئلة الواقع العربي الراهن.
السؤال عن مدى حاجتنا اليوم إلى استرجاع الفكر الخلدوني ليس سؤالًا أكاديميًا خالصًا، ولا تمرينًا في استعادة تراث ماضٍ، إنه سؤال وجودي يتصل مباشرة بأزمة الواقع العربي المعاصر، فالعالم العربي يعيش لحظة تاريخية تتكاثف فيها الأزمات البنيوية (سياسية واجتماعية، واقتصادية)، أزمة الدولة بوصفها إطارًا جامعًا، أزمة الشرعية السياسية، أزمة الاقتصاد المنتج، وأزمة الهوية في علاقتها بالحداثة والعالم، هذه الأزمات لا تبدو معزولة أو طارئة، ولكنها تتخذ طابعًا دوريًا عميقًا، يذكّر، في كثير من وجوهه، بما وصفه عبد الرحمن بن خلدون في تحليله لدورات العمران وصيرورة الدول. حين نقرأ واقعنا العربي على ضوء المفاهيم الخلدونية، نلحظ تفكك العصبيات الجامعة التي كانت تشكّل في لحظات تاريخية سابقة أساس التماسك الاجتماعي والسياسي. لم تعد الروابط الكبرى، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو رمزية، قادرة على إنتاج شعور فعلي بالانتماء المشترك. وفي المقابل، تتكاثر العصبيات الجزئية، الطائفية أو القبلية أو الفئوية، فتتحول من طاقات تضامن إلى عوامل تفكك. هذا ما يجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة متوترة، يغلب عليها الشك وانعدام الثقة، وتفقد فيها الدولة قدرتها على تمثيل المجتمع أو التعبير عن مصالحه العميقة. في هذا السياق، يكتسب الفكر الخلدوني أهمية خاصة لأنه لا ينظر إلى الدولة باعتبارها كيانًا قانونيًا مجردًا أو مؤسسة إدارية معزولة، بقدر ما يراها نتاجًا معقدًا لشبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالدولة عند ابن خلدون تنشأ حين تتوافر شروط القوة والتضامن والإنتاج، وتضعف حين يختل هذا التوازن. هذا المنظور يسمح بفهم أزمات الدولة العربية المعاصرة بعيدًا عن الخطابات التبسيطية التي تردّ الفشل إلى سوء أشخاص أو مؤامرات خارجية فقط، دون النظر في البنية الاجتماعية التي تحمل الدولة أو تفرغها من مضمونها. كما يقدّم الفكر الخلدوني أداة ثمينة لفهم العلاقة المختلة بين ما يمكن تسميته اليوم بالبداوة والحضارة، لا بمعناهما التاريخي الضيق، وإنما بوصفهما نمطين من الوجود الاجتماعي. فالبداوة عند ابن خلدون ترمز إلى الخشونة، وإلى الاقتصاد القائم على الضرورة، وإلى روابط التضامن الأولية، بينما ترمز الحضارة إلى الترف، وتعقّد العمران، وتحوّل القيم. حين تفقد المجتمعات قدرتها على إدارة هذا الانتقال إدارة متوازنة، تنشأ أزمات عميقة، حيث لا تعود القيم البدوية قادرة على إنتاج دولة مستقرة، ولا القيم الحضرية قادرة على الحفاظ على التضامن الاجتماعي. هذا التشخيص يبدو اليوم شديد الراهنية في مجتمعات عربية تعيش مظاهر حداثة شكلية دون أن تمتلك شروطها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. غير أن استرجاع الفكر الخلدوني لا يعني نسخه أو تطبيقه حرفيًا على واقع مختلف جذريًا من حيث الزمن والبنية. ابن خلدون نفسه لم يقدّم وصفات جاهزة، ولكن منهجًا في النظر والتحليل واعمال (العقل الاجتماعي)، واستعادته اليوم تعني استلهام هذا المنهج، أي النظر إلى الواقع بوصفه ظاهرة قابلة للفهم، لا لغزًا ميتافيزيقيًا، وربط السياسة بالاقتصاد، والسلطة بالمجتمع، والتاريخ بشروطه المادية والثقافية. بهذا المعنى، يصبح الفكر الخلدوني تمرينًا على التفكير المركّب، لا مرجعًا للتكرار.
بمعنى آخر الفكر الخلدوني يعلّمنا كذلك أن نقرأ التاريخ قراءة وظيفية نقدية، لا احتفالية(انتشائية)، التاريخ عنده مختبرًا للتجربة الإنسانية، وليس مخزنًا للأمجاد ولا سردًا لبطولات السلاطين، تتكرر فيه الأنماط وتتحول وفق قوانين يمكن رصدها. هذا الدرس بالغ الأهمية في سياق عربي ما زال يتعامل مع الماضي إما بوصفه عبئًا يجب التخلص منه، أو بوصفه ملاذًا تعويضيًا للهروب من الحاضر. كلا الموقفين يعطّل إمكان الفهم. أما القراءة الخلدونية، فتقترح علاقة ثالثة بالتاريخ، علاقة قائمة على الفهم، التحليل والتعلّم. وفي اعتقادي يذكّرنا ابن خلدون بأن أي نهضة لا تقوم على فهم عميق لبنية المجتمع محكوم عليها بالهشاشة. لا يمكن استيراد نماذج جاهزة للدولة أو التنمية أو الديمقراطية دون إدراك الشروط الاجتماعية التي تجعل هذه النماذج قابلة للحياة. هذا التحذير يبدو اليوم أكثر إلحاحًا في زمن تتسارع فيه التحولات العالمية بما فيها هيمن ة الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، وتتعمق فيه الفجوة بين السلطة والمجتمع، وتتآكل فيه الثقة في المؤسسات. مع ذلك، فإن استرجاع الفكر الخلدوني يواجه تحديات حقيقية. أول هذه التحديات يتمثل في ضرورة تحرير ابن خلدون من القراءات المدرسية الجامدة التي حوّلته إلى مجموعة مفاهيم محفوظة. إدخاله في نقاشات معاصرة حول الدولة الحديثة، والاقتصاد السياسي، وعلم الاجتماع النقدي، يقتضي شجاعة معرفية وقدرة على المقارنة والتجاوز. ثاني التحديات يتمثل في غياب مؤسسات بحثية وتعليمية تتعامل مع التراث بوصفه مادة حية قابلة للتجديد، لا بوصفه ماضيًا منتهيًا أو رمزًا للشرعية الثقافية. أما التحدي الثالث، فهو سياسي وثقافي في آن، ويتعلق بوجود إرادة تسمح بانتشار فكر نقدي لا يخضع لمنطق التبرير ولا يخشى مساءلة البنى القائمة.
يمكن القول إن تأخر العرب في الانفتاح الحقيقي على فكر عبد الرحمن بن خلدون ليس مسألة إهمال عرضي أو نقص في الوعي الفردي، بقدر ما هو نتيجة تفاعل معقد بين السياسة والمعرفة وطريقة فهم التراث. القراءة السطحية لفكر ابن خلدون ليست قدرًا محتومًا، وإنما نتيجة بنى تعليمية وثقافية تخشى التعقيد والنقد. أوروبا لم تنهض على كتفي ابن خلدون وحده، لكنها استفادت من روحه المنهجية التي ترى في الاجتماع البشري موضوعًا للفهم لا للتقديس. واليوم، يبدو العالم العربي في حاجة ماسّة إلى هذا النفس التحليلي، من أجل إعادة بناء علاقتنا بالواقع، وبالتاريخ، وبأنفسنا.
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com