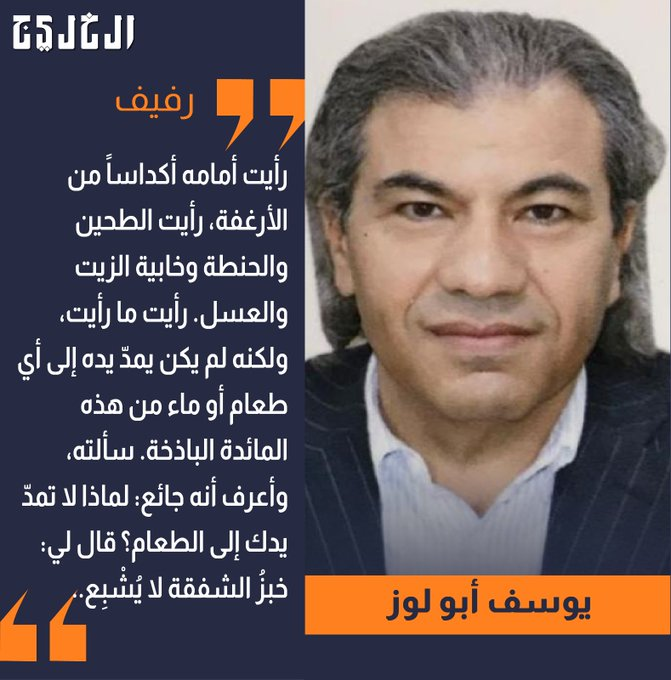د. محمد حبيب الله: من هنا نبدأ.. لمحة تاريخية عن واقع مدارسنا العربية في اواخر الخمسينيات!
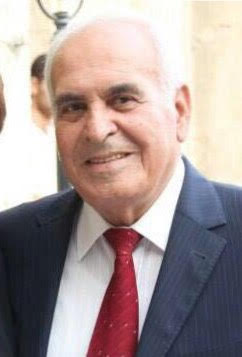
لا زلت اذكر مدرستي الاولى في عين ماهل والتي كانت مؤلفة من غرفة واحدة بنيت من حجر زمن الانتداب البريطاني وعلى نفس النمط الذي بنيت فيه مدارس اخرى في قرانا العربية. كان ذلك في اواسط الاربعينات من القرن الماضي وقبل قيام دولة اسرائيل (1948) كنت حينها وفي السنة الدراسية 1947/1946 في الصف الاول.
كان في هذه الغرفة متسعا للصفوف من الاول حتى الرابع هذا بالإضافة الى “صف الطاولة” الذي كان يجلس فيه على طاولة ممتدة من يسار المدخل حتى الحائط ويتسع لأولاد لم يبلغوا من العمر سنا يؤهلهم للدخول للصف الاول وهو صف نسميه هذه الايام في المدارس الاهلية الصف التمهيدي وكان من خلال وجودنا في هذا الصف ان تعلمنا سماعا بدايات اللغة العربية قبل ان ندخل الصف الاول الرسمي.
كانت الغرفة بمثابة المدرسة والتي تتسع للمدير والمعلم والطلاب جميعهم كانوا يجتمعون في غرفة واحدة وكان المعلم الواحد ينجح في تعليم الصفوف من الاول حتى الرابع وفي نفس الوقت وبطريقة نسميها اليوم طريقة التعليم في “صفٍّ غير متجانس”، كان الطلاب ذوي مستويات مختلفة سنا وموضوعا ولاحقا.
وفي بداية الخمسينيات بنيت غرفتان اخريتان من حجر وعلى نفس النمط الذي بنيت فيه الغرفة الاولى فصارت المدرسة مؤلفة من ثلاث غرف توزعت فيها الصفوف من الاول حتى الرابع ثم تطورت وزيدت عليها الصفوف الخامس والسادس.
كان الطلاب الذين ينهون الصف السادس يذهبون الى مدرسة كفر كنا القريبة مشيا على الاقدام يوميا بهدف التعلم في الصف السابع. لقد دعت الحاجه فيما بعد وبسبب زيادة عدد الطلاب في اواخر الخمسينات واوائل الستينات الى استئجار غرف تابعة لجيران المدرسة لا تصلح الدراسة فيها. وكان يتعلم فيها الاولاد من الصفوف الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
في اوائل الخمسينات وبعد سن قانون التعليم الالزامي تطورت المدرسة كمّا وعددا ودعت الحاجة الى تعيين معلمين لم ينهوا احيانا الصف السابع. كان جميع المعلمين غير مؤهلين، وقد وصلت نسبتهم في المدارس العربية الى اكثر من 95% من عددهم.
في المدارس العربية بدأت في اواخر الستينات حركة استكمالات مكثفة لتأهيل المعلمين ودعوتهم الى دورات يتعلمون فيها مواضيع عامة، مثل الطبيعة والتاريخ والرياضيات ومواضيع التربية وعلم النفس والاساليب التدريسية العامة والخاصة، ومواضيع اخرى مطلوبة كي يكون المعلم مؤهلا وفي مستوى تعليمي يشابه انهاء المدرسة الثانوية.
انهيت المدرسة الابتدائية سنة 1954 وكنت من الذين نجحوا في امتحانات “الثوامن”، هذا النجاح الذي أهلني للتعلم في المدرسة الثانوية مجانا وعلى حساب وزارة المعارف. لا زلت اذكر ان عدد الطلاب الذين نجحوا في صيف 1954 كان خمسة عشرة طالبا من المدارس في الجليل وكنت انا واحدا من هؤلاء الطلاب.
كنا انا ومحمود ومصطفى نذهب يوميا مشيا على الاقدام للناصرة اما عن طريق الوصول الى المشهد او الرينة للحاق بالباص الذي كان يخدم السكان من قرية طرعان مرورا بكفر كنا والمشهد والرينة حتى الناصرة.. كنا في فصل الشتاء نستأجر في “الحارة الشرقية” في الناصرة غرفا للمبيت فيها وكنا نذهب يوميا الى بابور الطحين “قنازع” لتناول “الزوادة” التي كان يرسلها لنا الاهل مع الذين يحضرون الى البابور لطحن القمح.
لا زلت اذكر انني وصديق عمري مصطفى (ابو عزمي لاحقا) كنا المعلمين الاوائل في القرية بعد ان أنهينا المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة (1958) ودار المعلمين في يافا (1960). وقد كنا الفوج الاول لهذه الدار الذي كان يتعلم سنتين من اجل ان يصبح “معلما مؤهلا”.. لقد جئنا من اكثر من عشرين قرية ومدينة في الشمال والمثلث وانهينا دراستنا في صيف 1960.
عُيّنتُ معلما ونائبا للمدير من الاسبوع الاول من السنة الدراسية ايلول 1960. كان ينقص وظيفتي خمس حصص تعليمية اكملتها في مدرسة دبورية الابتدائية، حيث كنت اذهب صباح كل خميس مشيًا على الاقدام الى دبورية، واعلّم هناك الحصص الخمس موضوع الموسيقى والرسم، وكنت انام عند صديق لي رافقني قبلًا في دراستي الثانوية وفي دار المعلمين، هو الاستاذ امين شحبري الذي تعيّن فيما بعد مفتشا في الوزارة.
كنا في صباح الجمعة نستقل الباص الى الناصرة حيث يجتمع كثير من المعلمين في مطعم “ابو ماهر” في منطقة عين العذراء لتناول طعام الإفطار: “صحن حمص ولحمة”. وهذا كان اقصى ما كنا نتمناه.
كانت الناصرة مركزا للتجمعات السكانية من القرى المجاورة وكانت “المسكوبية” القريبة من مطعم “ابو ماهر” مقرا للحاكم العسكري، حيث كان يتوافد المخبرون الى هناك لنقل اخبار حول تحركات اهل القرية وما كانوا يتفوّهون به من كلمات تتصل بقضايا الامن. لقد كان في هذه الفترة هيمنة للشاباك.
كان المفسدون يفعلون الكثير من اجل مراقبة المعلمين بالذات ونقل اخبار عنهم في كل ما يتعلق بقضايا امنية او قومية وطنية او بالأمور الفلسطينية. وقد كان محظورا على المعلمين وحتى اواخر الستينات التفوه بكلمة “فلسطين” هذه الكلمة التي كانت تعتبر “مخالفة امنية”. وكان محظورا على المعلمين قراءة جريدة “الاتحاد” التابعة للحزب الشيوعي، واعتبروا ذلك “مخالفة كبرى” يعاقَب عليها.
كانت الاخبار تصل الى الحاكم العسكري ورجال “الشاباك” من “المفسدين”، وتؤدي الى ردود فعل ضد كل معلم “مخالف”. وكان يصل العقاب الى درجة فصل المعلم من عمله، او ابعاده الى قرية نائية للتعليم فيها من اقصى الشمال في الجليل الى اقصى الجنوب في قرى المثلث ومدارس البدو في النقب. هذا بالإضافة الى ان هذا الامر كان معيارا هاما في القرارات، التي تتصل بتعيين المعلم او الحصول على وظيفة مدير او نائب مدير.
اذكر في اوائل الستينات وفي ظل ازمة الغرف الدراسية اننا كنا نتجول مديرا ومعلمين في حارات القرية لجمع تبرعات من اجل بناء الجناح الغربي في المدرسة، والذي تألف من خمس غرف. لا زلت اذكر اننا عندما وصلنا الى أحد بيوت القرية لطلب التبرع كان يقف احد طلابي امام البيت. وعندما سألته: هل ابوك في البيت؟ من اجل الدخول الى البيت واخذ تبرع منه للمدرسة، عندها دخل “عاطف” الى البيت ورجع بعد قليل ليقول لنا: “ابوي بقلكو انو هو مش هون”، عندها ضحكنا من هذا الجواب ودخلنا البيت وفاجأنا ابو عاطف في الداخل ولا حاجة لشرح ما حصل للاب من مشاعر يغلب عليها الخجل بسبب ما فعله. وكان هذا بالنسبة لنا سببا قويا في جعله يتبرع لنا بمبلغ كبير نسبيا!
كانت مدرسنا في الخمسينات والستينات تعيش في ظروف قاسية، لا اثاث ملائم ولا ماء ولا كهرباء ولا منافع ولا حمامات من اجل قضاء حاجات لا بد من قضاءها، وكان البعض الذي لا يستطيع ضبط نفسه يذهب بعيد ويختبأ وراء صخرة من اجل قضاء حاجته. اذكر انني كنت صديقا في اوائل الخمسينات لابن صفي “خالد”- ابن عمتي “ندى”، وابن صفي “محمد” – ابن خالتي “نصيري”، كون دارهم تقع بجوار المدرسة. وكنت استغل هذه الصداقة من اجل القفز الى بيت احدهما والتمكن من شرب ماء ومن اكل قطعة من الخبز. هكذا كان الوضع، وهكذا كانت حياتي في اواخر الاربعينيات واواسط الخمسينيات من القرن الماضي في المدرسة الابتدائية.
وعطفًا ما ذكرت اعلاه من تسلط الحكم العسكري و”الشاباك” على المعلمين، لا بد من ذكر احداث تتصل بهذه الملاحقات اقول ذلك لدوافع ثلاثة:
* الدافع الاول حرصا على الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تصف “هذيك الايام”، وتشرح كيف كان وضع المدارس والمعلمين في تلك الفترة وفي ظل الحكم العسكري وسيطرة “الشاباك”.
* والدافع الثاني هو دافع الحنين الى زمان مضى والى اناس تقلبت بهم الحياة، ولم تكن سهلة عليهم حيث كان الناس يجلّون ويحترمون المعلم ويقدّسونه. هذا بالإضافة الى الحنين الى جيل من الطلاب اصبحوا اليوم رجالا يملؤون الآفاق نبضًا وعطاءً – كما ورد ذلك على لسان الشاعر شكيب جهشان، رحمه الله، في كتابه “لذكرى ايام غوال”، والذي وصف فيه كيف كانت بداياته في مهنة التعليم في قرية العزير، ومن ثم في قرية دير الأسد، ولاحقا في مدرسة الرامة الثانوية معلما للغة العربية.. يقول شكيب في كتابه: “لقد حاولت ان اوضح للذين لا يعرفون كيف عمل هذا الجزء من شعبنا المتبقي في ترابه، كيف عمل بأظافره وبنبضاته وبأنفاسه من اجل تثبيت مكان له تحت الشمس”.
* اما الدافع الثالث فكان نقل التجربة التي مررت بها ومر بها كثيرون امثالي وبمنتهى الامانة للأجيال الآتية، علّها تستفيد منها او علها تتحاشى بعض المرارة التي ذاقها السابقون.
يجد القارئ في هذا الكتاب مقالات كثيرة تتصل بهذا الموضوع، وبالوضع الذي عاشه المعلمون في ظل الحكم العسكري وما بعده. وبالتجارب التي مررت بها شخصيا، لا بد من الاشارة الى ان كثيرا من المعلمين – وفي ظل المنهاج الذي وضعته الوزارة للعرب في إسرائيل، والذي كان يتنكر لتاريخ العرب وتراثهم الحضاري وللوجود العربي في البلاد، ويتعاملون معه من خلال سياسات القهر والحرمان وتعميق الغربة – كان البعض منهم يتحايل على المنهاج من اجل تذويت الانتماء والهوية عند الطالب. وعندما كانوا يعلّمون قصيدة لإبراهيم طوقان مثلا، كانوا يشرحون للطلاب كيف كان هذا الشاعر وطنيا، وكيف كان يحارب وجود الاستعمار البريطاني. نعم، كان المعلمون يتحايلون على المنهاج ويتخذونه منطلقا لتعليم اشياء كثيرة تتصل بالهوية والانتماء وترسيخ امور لم يؤكدها المنهاج التعليمي!!
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com